البطالة القادمة ليست بلا عمل.. بل كيف تتغير الوظيفة في الذكاء الاصطناعي؟
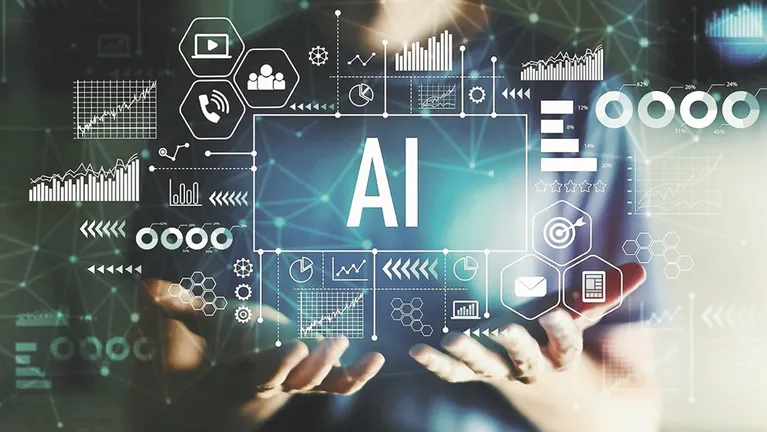
د. مروة بنت سلمان آل صلاح *
عمان- “في عصرٍ تتعلم فيه الآلات بسرعة، لم تعد قيمة الإنسان في ما يعرف، بل في كيف يفكر، ولماذا يختار.”
البطالة ليست فقدان وظيفة بل انكشاف دورك الزائف.
في عالم يتبدل أسرع من قدرة البشر على الفهم، لم يعد فقدان الوظيفة هو الكارثة الحقيقية. الكارثة الأعمق أن تكتشف — فجأة— أن ما كنت تسميه “عملا” لم يكن سوى تكرار أجوف، إن وجودك الوظيفي لم يكن نابعا من قيمتك، بل من فجوة مؤقتة في قدرة الأنظمة. ومع صعود الذكاء الاصطناعي، لم تعد المسألة “هل ستأخذ الآلة مكاني؟”، بل “هل كنت في مكاني أصلًا؟”.
في زمن تتقن فيه الآلة المهام، وتتسع فيه فجوة المعنى، تتجلى البطالة لا كحالة مادية بلا دخل، بل كمرآة فاضحة تظهر أننا لم نكن ننتج فرقا بل نكرر ما يمكن أن يبرمج. إنها الهشاشة الوظيفية الصامتة، حيث نبقى في مقاعدنا بينما تنهار قيمتنا من الداخل.
تخيل موظفا مثاليا، لا يخطئ، ينجز مهامه اليومية بإتقان، يحضر باكرا ويغادر في الموعد، يحفظ الإجراءات ويطبقها بحذافيرها. ثم، وذات صباح، يبلغ بأن خوارزمية ذكية ستحل محله. ليس لأنه أخطأ، بل لأن الدقة لم تعد كافية، والسرعة لم تعد ميزة، والالتزام وحده لم يعد قيمة.
هذه ليست قصة من الخيال العلمي، بل هي نبوءة تتحقق بصمت في مكاتب كثيرة حول العالم. فالبطالة القادمة ليست غياب العمل، بل غياب المعنى. لم تعد الوظيفة مجرد إطار تنظيمي، ولا مرادفا للقيام بسلسلة من المهام المتكررة. نحن أمام التحول الوجودي للوظيفة، حيث يقاس الموظف ليس بكم ينجز، بل بنوع الأثر الذي يحدثه، وبالمعنى الذي يضيفه داخل النظام — بمعنى آخر، ندخل تدريجيا إلى اقتصاد المعنى.
في هذا التحول العميق، لم يعد السؤال هو: “كيف نحافظ على الوظائف؟”، بل: “كيف نصنع وظائف لا يمكن استبدالها؟”. المهام الروتينية من إدخال بيانات، مراجعة فواتير، وحتى خدمة العملاء، أصبحت تنفذ بواسطة أنظمة ذكية تتعلم وتتطور. وهذا لا يعني أن الإنسان أصبح بلا قيمة، بل يعني أن عليه إعادة اكتشاف ذاته في المساحات التي لا تستطيع الآلة أن تخترقها: البصيرة، الحس القيمي، الذكاء العاطفي، والتأويل الإنساني للمعطيات — ما يعرف اليوم بـالذكاء التأويلي.
البطالة التقنية ليست مؤامرة من الذكاء الاصطناعي، بل نتيجة طبيعية لتأخر النظم البشرية — التعليمية، والإدارية، والتدريبية — عن اللحاق بإيقاع التحول. إن الوظائف لا تختفي فعليا، بل تتبدل هوياتها، وتنتقل من التنفيذ إلى التفكير، من الحفظ إلى الفهم، من التلقي إلى الإنتاج. وكل من لم يطور نفسه ليتفاعل مع هذه الهوية الجديدة، سيتحول حتما إلى فائض بشري رقمي داخل منظومة ذكية لا تنتظر.
ولأن هذا التحول لا يرحم الجمود، فإن النموذج الجديد للعمل لا يقصي الإنسان، بل يتطلب منه أن يتحالف مع الآلة، لا أن يواجهها.
وهنا يظهر العقل الهجين كمفهوم جوهري: عقل بشري يتكامل مع الذكاء الاصطناعي، لا ينفصل عنه ولا يذوب فيه. إنه العقل القادر على الجمع بين البصيرة الإنسانية والدقة الخوارزمية، بين التعاطف والتحليل، بين الإبداع الفطري والاستدلال الرياضي. في هذا العقل، لا يصبح الإنسان نسخة من الآلة، بل يتجاوزها من حيث المعنى والقيمة.
بل أكثر من ذلك، نحن بحاجة إلى عقل ما بعد خوارزمي، لا يكتفي بفهم الآلة، بل يتقن إعادة صياغة الأسئلة التي تبرمج عليها.
هنا، يظهر مفهوم “الموظف الذكي” — الإنسان الذي يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لا ليستبدل بها، بل ليعزز إمكاناته بها. في السياق الأردني مثلا، يمكن لهذا المفهوم أن يحدث نقلة نوعية في القطاع الحكومي، حيث يصبح الموظف شريكا في تحسين الخدمات، لا مجرد منفذ للإجراءات.
تصور موظفا في مؤسسة البريد، يستطيع عبر أدوات تحليل سلوكي أن يتوقع طلب العميل قبل أن يعبر عنه، ويقترح له الحل الأنسب بناء على بياناته وسجلاته السابقة. لم تعد مهمته في هذه اللحظة هي “تقديم الخدمة”، بل “هندستها”، بناء على فهم للسياق، وتنبؤ بالحاجة. هنا، تتحول الوظيفة من معالجة إلى بصيرة، وندخل رسميا في عصر اقتصاد البصيرة.
ولكن، ماذا عن نظم التقييم؟ ما تزال مؤسسات كثيرة في عالمنا العربي تقيس الموظف بعدد ساعات حضوره، وعدد المعاملات التي أنجزها، لا بقدرته على التفكير النقدي، ولا بجودة القرار الذي اتخذه في ظرف معقد، ولا بمدى تعاونه مع الفريق. العقل المعرفي لا يقاس بالكم، بل بالكيف، ولا يمكن استيعابه ضمن جداول الحضور والانصراف.
وهنا، لا بد من إصلاح إداري يواكب هذا التحول، لا يقف في وجهه. إصلاح يعيد تعريف معايير الأداء، ويحتفي بالتحليل بدلا من الحفظ، وبالقيمة المضافة لا بالمهام المنفذة.
المشكلة لا تبدأ من مكان العمل فقط، بل من المدرسة والجامعة. مؤسسات التعليم ما تزال، في كثير من السياقات، تخرج أفرادا يجيدون تكرار ما قيل لهم، ويخشون طرح الأسئلة. في حين أن السوق الجديد لا يحتاج إلى من “يعرف الإجابة”، بل إلى من يشكك في السؤال ذاته، ويعيد صياغته بلغة معرفية جديدة.
فهم الخوارزميات لم يعد كافيا، بل لا بد من مقاومة الانبهار بها. وتحليل البيانات لم يعد ميزة، ما لم يرفق بوعي إنساني يدرك أن وراء كل رقم حكاية، وكل نمط احتمال، وكل خوارزمية انحياز خفي. الذكاء العاطفي، والقدرة على اتخاذ قرارات أخلاقية في بيئات رمادية، لم تعد مهارات “ناعمة”، بل أصبحت ضرورة صلبة للنجاة.
وفي الختام، لسنا في مواجهة الذكاء الاصطناعي بقدر ما نحن في مواجهة حقيقتنا. الوظيفة لم تعد تذكرة عبور إلى الحياة، بل اختبارا مستمرا لمعنى وجودنا داخلها. من يكرر، يستبدل. ومن يضيف، يبقى.
البطالة القادمة لن تقاس بعدد العاطلين عن العمل، بل بعدد الذين ظنوا أن أداء المهمة يكفي ليكونوا ضروريين. في هذا العصر، لم تعد القيمة في عدد الساعات، بل في نوع السؤال الذي تطرحه، وفي الأثر الذي لا يمكن نسخه أو برمجته. تلك هي النجاة المعنوية، حيث لا تنقذك المهارة وحدها، بل معناها.
فمن لا ينتج معنى، لن ينجو بوصف “موظف”، بل سيندثر كوظيفة لم تعد تجدي في زمن اللاعمل المقنّع.
*مطور للمدن الذكية والاقتصاد الرقمي





